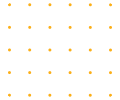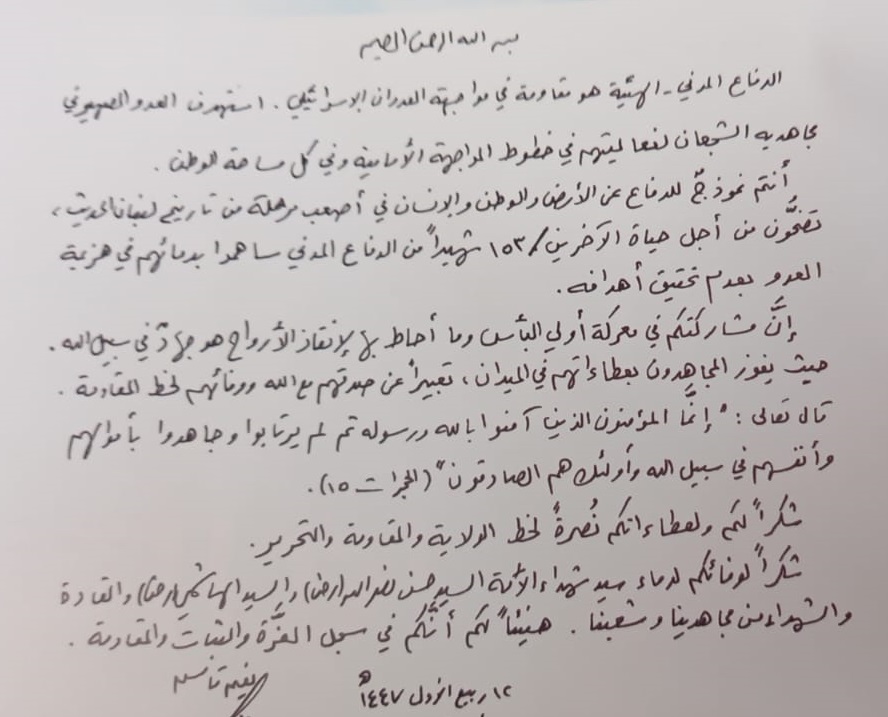الكلمة التي ألقاها نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في قاعة لجنان في اليوم الرابع من محرم الحرام لسنة 1423هـ وهي بعنوان" أثر عاشوراء في حياة الأمة:
السلام على الحسين، وعلى جد الحسين ،وعلى أب الحسين، وعلى أم الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى الشهداء الأبرار والنساء الخيرات، والأبناء الأطهار الذين قاتلوا وجاهدوا وصمدوا ورفعوا بإعزاز كلمة الحق، والسلام على شهداء الإسلام في كل زمان ومكان وخاصة شهداء المقاومة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام على الحسين، وعلى جد الحسين ،وعلى أب الحسين، وعلى أم الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى الشهداء الأبرار والنساء الخيرات، والأبناء الأطهار الذين قاتلوا وجاهدوا وصمدوا ورفعوا بإعزاز كلمة الحق، والسلام على شهداء الإسلام في كل زمان ومكان وخاصة شهداء المقاومة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كربلاء تركت آثارها وبصماتها بشكل مباشر وفعال في حياة الأمة، لكن الأمة لم تدرك هذه الآثار إلا بعد فترة طويلة من الزمن، فقد ظن البعض أن كربلاء محطة وتعاطى معها كحادثة في التاريخ، لكن البعض الآخر عمل على إحياء كربلاء لتحيا من ناحية فتحيا مقوماتها، وتحي من ناحية أخرى فتأخذ الأمة منها ما تحتاجه لحياتها، لذا ليس غريباً أن نرى آثار كربلاء قد برزت بشكل جلي بعد مئات السنين من خلال أحداث نموذجية وآثار عملية انعكست كتغيير في الأمة. ولعل أبرز حدثين من أحداث كربلاء هما الثورة الإسلامية المباركة في إيران والانتصار الكبير على الجيش الإسرائيلي في لبنان، وهذا لا يعني أن كربلاء اختزنت مضامينها لتفجرها في هذه اللحظة، فهناك صعوبات وعقبات، وهناك مقومات لا بدَّ أن تتوفر لتعطي كربلاء نتائجها، لكن بالتأكيد توفرت مجموعة الشروط المطلوبة حتى عاشت كربلاء مجدداً وأحيت من سارت معها.
هناك عنوانان لكربلاء لا يمكن لأحد أن يتخطاهما، بل إذا أردنا أن نركز على حقيقة كربلاء فإنهما يمثلان أمامنا بشكل مباشر قبل أن نصل إلى أي عنوان آخر من العناوين الملحقة بكر بلاء.
أما العنوان الأول فهو الموقف الذي عبر عنه الإمام الحسين(ع) بصمود وثبات وثقة وتصميم لإعادة البوصلة إلى الإسلام المحمدي الأصيل، ولتأكيد منهج لا بدَّ أن يتبعه المسلمون حتى يحافظوا على نهج رسول الله(ص)، هذا الموقف رأيناه يبرز من كلمات الإمام ومواقفه في محطات مختلفة، منها محطة المدينة المنورة عندما خرج ليلاً منها ليومين بقيا من شهر رجب في سنة ستين للهجرة، وقبل أن يغادر ترك كتاباً عُبر عنه بالوصية لأخيه محمد بن الحنفية، يبين في هذا الكتاب أهداف حركته وطريقة أدائه وما يريد أن يصل إليه، قال:" إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب(ع)، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين" وهذه الكلمات تبين بوضوح ذاك الهدف الذي خرج من أجله، "إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي" فالفساد استشرى والإصلاح يتطلب موقفاً،" أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر" لا الأمر بالمعروف الفردي أو النهي الفردي بل الأمر بالمعروف الذي يرتبط بالأمة، يريد أن يسير بسيرة جده(ص) وأبيه(ع) على قاعدة أن هذه السيرة هي السيرة الأساسية التي تحكم المسار والتي يمكن الأخذ من معالمها باطمئنان بسبب العصمة لنبينا الأكرم(ص) وإمامنا أمير المؤمنين(ع)، وكان واضحاً هو لا يتوقع أن يتقبل القوم، " فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن ردَّ عليَّ أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين" من هنا الموقف واضح من أجل الرسالة، سواء وافقت الأمة أو رفضت، وسواء كتب لهذا الموقف النصر أو الهزيمة، وسواء تمكن هذا الموقف من أن يصنع الحل بشكل آني أو أسس للحل المستقبلي، فلم يكن الإمام(ع) ملتفتاً لأي عنوان من العناوين الأخرى، ولم يكن معيراً أهمية لأي عنوان من العناوين الأخرى، لأن الكيل طفح والأمة أصبحت بخطر والإسلام معرض للذوبان أو الانحراف فلا بدَّ من الموقف الذي يثبت خطوات الإسلام الحقيقية مهما كان الثمن ومهما كانت المعطيات.
وكرر الأمر عندما وصل في طريقة إلى كربلاء إلى منطقة تُسمى البيضة، وهناك التقى بعسكر الحر الذي أراد أن يمنعه بعد ذلك من الوصول إلى الكوفة أو العودة إلى المدينة المنورة، هناك خطب في القوم وكانت الظروف سانحة ليبين لهم علَّهم يعودون إلى طاعة الله تعالى، فقال نقلاً عن رسول الله(ص):" إن رسول الله(ص)قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله(ص)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يُدخله مدخله" يعني أن يكون هذا الإنسان مع هذا الظالم في نفس الموقع والنتيجة في الدنيا وفي الآخرة،" ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود ..." إلى آخر الخطبة التي تحدث عنها إمامنا الحسين(ع)، مما يبرز أن الموقف الذي نتلمسه من الإمام الحسين(ع) هو إسقاط الحاكم الظالم، لا إسقاط شخص تولى على المسلمين، بل الإسقاط لمنهج إذا تربع على قاعدته هذا الحاكم فإن الأمة ستتضرر بمنهج جديد يحاول هذا الحاكم أن يؤسس ويروج له، فالهدف ليس الحاكم كحاكم بل الهدف هو هذا الذي يدعي أنه يحكم بالإسلام، فالإسلام يختلف عن حكمه، والإسلام لا يقبل بمثله، والإسلام أسس على استقامة لا يستطيع يزيد اللعين أن يطبق هذه الاستقامة، من هنا كان لا بدَّ من الموقف من أجل تثبيت تعاليم الإسلام الحقة، فهذا الخليفة هو مخالف لسنة رسول الله(ص)، ولا يعبر عن المضمون الإسلامي ولا بدَّ أن يسقط، فالموقف واضح. هناك رغبة أكيدة وقناعة راسخة بإعادة طاعة الله في مقابل طاعة الشيطان، ولا يمكن أن تعود طاعة الله تعالى على الأرض وبين المسلمين إلاَّ إذا اسقط يزيد الذي عاث في الأرض فساداً، والذي تميز بشخصية منحرفة أمام الأمة.
ثم كرر إمامنا الحسين(ع) هذا الموقف أيضاً، كموقف رسالي يحافظ على الشريعة المقدسة، عندما وصل الأمر إلى كربلاء، فبعد خطبته الأولى جاءه قيس بن الأشعث من معسكر ابن زياد، فقال له: أولا تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. وهذا نوع من الجاذبية التي يريد قيس بن الأشعث أن يُشعر الإمام بأنه محفوظٌ في بعض المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها، وكأن الإمام قد وقف هذا الموقف حفاظاً على شخصه وحفاظاً على مكانته وحياته. فرد عليه الإمام بكلمته المشهورة" لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد" هذا أمرٌ مستحيل لأني إذا وافقتكم وأعطيتكم وشرعت قيادتكم، فهذا يعني أن الإسلام أصيب بالانحراف، وأن الإسلام دُمر فلن أكون عبداً لمصلحة دنيوية آنية، ولن أذل أمام مصالح آنية، بل سأبقى في الموقف الحق "لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد"، هذا الموقف هو الذي حكم مسار الإمام الحسين(ع) من البداية إلى النهاية، وكان موقفاً ثابتاً يؤكد المحافظة على الإسلام وعلى استقامة تطبيقه في الحياة. وهنا يأتي السؤال: ألم يكن بالإمكان أن يتغير هذا الموقف إنسجاماً مع قلة الناصر والمعين؟ فهذا علي(ع) قبل بخلافة الأول ولم يقاتل، وهذا إمامنا الرضا (ع) قبل بولاية العهد ولم يقاتل، وهذا إمامنا الحسن(ع) قبل بالصلح مع معاوية ولم يقاتل، فإذا كنا نتحدث عن موقف حسيني فهل هذا الموقف يختلف عن المواقف المشابهة التي تتراءى لنا للوهلة الأولى أنها مواقف مطلوبة من أجل المحافظة على الدين؟ إذن لماذا لم يكن الموقف بنفس الاتجاه ليؤدي إلى النتيجة التي أدت إليها كربلاء؟
يمكننا أن نراقب بدقة حركة أمير المؤمنين علي(ع) والظروف التي أحاطت به، فقد عرض عليه البعض أن يقاتل ومنهم أبو سفيان على قاعدة تقاطع المصالح في محاولة الوصول إلى كسب، إذ أنه لم يكن راضياً عن النتائج لأن بني أمية لم يحصلوا على مكسب مباشر من الخلافة الأولى، فقال أمير المؤمنين علي(ع) مبيناً السبب المباشر لعدم وقوفه الموقف الذي يؤدي إلى القتال:" والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جوراً إلاَّ عليَّ خاصة" أنا أتحمل الصعوبات والضغوطات، وإذا لم أحكم الآن فعدم الحكم لن يؤدي إلى دمار وخراب في الأمة، ولن يؤدي إلى انتكاسة في دينها ومنطلقاتها، بينما إذا حاربت ستضمحل قدرة الدولة الإسلامية، وسيأتي الروم والفرس ليحكموا مجدداً وتسقط دولة الإسلام الناشئة، فتقدير الأمير للموقف هو تقدير الرافض لحركة باتجاه هذا الموقف لكنه لم يخف في لحظة من اللحظات طبيعة موقفه، ومن راجع الخطبة الشقشقية يرى تماماً تعبيرات الإمام في الألم والانزعاج وعدم الموافقة على ما جرى، ولكنه صبر من أجل الإسلام فهو اتخذ الموقف الذي اتخذه الإمام الحسين(ع) في إبقاء معلم الدين واضحاً لكنه لم ير ضرورة لنقل هذا الموقف بحركة قتالية في الأمة لأن نتائجها لن تكون في مصلحة هذا الموقف.
وهذا الأمر تكرر مع الإمام الحسن(ع)، الذي اعتبر الظروف غير ملائمة لوقوف موقف قتالي ضد معاوية، إذ أن هذا الموقف القتالي لن يؤدي إلى خدمة وفائدة للإسلام لكن في كل تعابير الإمام الحسن(ع) كان واضحاً أنه اضطر إلى الصلح، وكان واضحاً أن موقفه رافض لكن الظروف لم تسمح له بغير ذلك.
وأما الإمام الرضا(ع) فقد قبل ولاية العهد، لكنه اشترط أنه لا يأمر أمراً ولا ينهى نهياً ولا يمارس دوراً في ولاية العهد، مع العلم أن ولاية العهد تفترض بعض الصلاحيات التي يأخذها ولي العهد، والتي يقوم بأدائها، إلاّ أن الإمام وجد رفضه لولاية العهد سبيلاً إلى ضغط قد يؤدي إلى قتله وحرمان الأمة من وجوده دون أن يعطي نفعاً أو فائدة فلا بدَّ من المحافظة على الموقف بأسلوب لا يؤدي إلى القتال، فنفس رفضه لأن يبت بأمور ولاية العهد هو الإشارة الواضحة لكل المحبين أنه رافض لأداء الخليفة، لكنه في موقع يرى مصلحة الإسلام بالمحافظة على هذا الموقف بهذه الطريقة.هذا الموقف يدلنا أن المسلم مأمور بالمحافظة على موقفه دون أن يغير أو أن يعدل في مسار الفهم أو الوعي الإسلامي، وهنا وقع البعض في أزمة المقارنة بطريقة خاطئة فاعتبروا أن شهادة الإمام الحسين(ع) وموقفه تعبّران عن ظرف، وان صلح الإمام الحسن(ع) أو موقف أمير المؤمنين علي(ع) يعبر عن موقف آخر، فاعتبروا أن الموقف يمكن أن يتغير كما تغير من إمام إلى إمام بزعمهم، فأدخلوا عناوين في الإسلام ليست فيه، وأدلتنا إلى بعض انحرافات في الرؤية الفكرية والثقافية لأنهم نظروا لتنازلات في صلب الخط الإسلامي لم تطرح ولم يقبلها إمام معصوم وما لجأوا إليه من الحديث عن الموقف خطأ لأن الأئمة لم يتغيروا في مواقفهم إنما تغير الأسلوب إنسجاماً مع الظروف التي عاشوها بينما وقفوا موقفاً واحداً هو موقف الإسلام المحمدي الأصيل، هل ادخل الأئمة من غير الإمام الحسين(ع) شيئاً جديداً أو أخرجوا موقفاً من المواقف واستبدلوه بموقف آخر!؟ من راقب كلمات ومواقف الأئمة(ع) يجدها على نسق واحد فلم يغيروا في مواقفهم أبداً ولم يعدلوا فيها، فالموقف ثابت وقد يستطيع الإنسان تحقيق موقفه الثابت وقد يعجز عن تثبيته، هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بطبيعة موقفه، لأنه إذا تنازلت عن الموقف تحت عنوان الضغوطات سقط الدين وأصبحنا أما دين آخر، إنك إذا تنازل تحت الضغط عن قناعتك وعن التزامك وعن إيمانك هذا يعني أن الالتزام أخذ معنى آخر غير المعنى الذي انطلقت به، ولقد عرض الكافرون سابقاً على رسول الله(ص) وقالوا له ما رأيك ان نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة مناصفة؟ فنزل القرآن الكريم{قل يا أيها الكافرون* لا أعبد ما تعبدون* ولا أنتم عابدون ما أعبد* ولا أنا عابد ما عبدتم* ولا أنتم عابدون ما أعبد* لكم دينكم ولي دين} لا يمكن أن أجري مساومة على الدين، ولا يمكن أن أتنازل عن موقف ثابت له علاقة بالدين، وحتى عندما نتحدث عن المعاصرة التي يلجأ إليها البعض، ويعتبرونها انفتاحاً لمناقشة جديدة في الدين، نقول لهم: نحن مع المناقشة الجديدة في الدين، لكن لا على قاعدة أن نزيل أفكاراً وقواسم وثوابت في هذا الدين من أجل مسايرة الآخرين حتى نعبد إلههم سنة ويعبدوا إلهنا سنة، فالدين غير قابل للتغيير إذ{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وهذا الدين يحمل كمالاً في ذاته، فإذا كنا عاجزين عن فهمة في مرحلة من المراحل فلنبحث عن فهم للدين لا عن تغيير لنصوص الدين بحسب أفهامنا، وفرق كبير بين الأمرين، نحن مع مناقشة معاصرة لكننا لسنا مع إسقاط المعاصرة على الشريعة المقدسة، نحن مع مناقشة تفند الآراء بحرية دون ضغط الشارع ودون ضغط التراث الفقهي الكبير، لكننا لسنا مع مناقشة توصلنا إلى طريقة عوام الناس في الاستمزاج والاستئناس دون أدلة راسخة تقدم الدليل لتفهم الدليل الآخر المستند على أسس وبينات. وإذا واجهنا البعض بعجز عن هذا النمط نقول لهم: تذكروا قول أمير المؤمنين(ع):" ما حججت عالماً إلا وغلبته وما حاججت جاهلاً إلاَّ وغلبني" فإذا كان المقصود أن تؤمن بنا مجموعة الجهلة في العالم فقد أصبحنا جزءاً لا يتجزأ منهم، لأنه لا يمكن أن نؤمن كما يؤمنون إلا إذا أسقطنا القواعد والضوابط وأصبحنا نردد كما يرددون دون أسس وثوابت، أمّا إذا كان المطلوب أن يكون الموقف موقفاً ينبني على أسس واضحة فهؤلاء أئمتنا(ع) لم يغير أحد في موقفه، الإمام علي(ع) على موقفه ولكن اتخذ أسلوباً، والإمام الحسن(ع) ثبت الموقف لكنه لجأ إلى أسلوب آخر، والإمام الحسين(ع) أكد على الموقف واستشهد كأسلوب لدعم الموقف، والإمام الرضا(ع) سار مع الصعوبات ليحافظ على الموقف، واليوم ينقل لنا تاريخ الأئمة(ع) كموقف واحد لم يتغير عبر التاريخ.
فالعنوان الأول هو ثبات الموقف، الذي يجب أن نحافظ عليه، ليس مطلوباً منا أن ننتصر بموقفنا إنما المطلوب منا أن نحافظ على موقفنا لننتصر كأفراد في تكليفنا الشرعي حتى لو خسرت الجماعة، ليس مطلوباً منا ان نقيم دولة الإسلام على الأرض كيفما كان بتراجعات وتنازلات إنما المطلوب منا أن نحافظ على هذا الدين حتى لو لم تقم له دولة على الأرض، ليس تكليفنا أن نقيم الدولة، وليس تكليفنا أن ننتصر، وليس تكليفنا أن يصبح العالم بأسره مؤمناً، إنما تكليفنا أن نحمل الحق "فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين"، لذا عندما نفهم الرسالة كموقف وتشريع نثبت أمامها ولا نخضع لابتزازاتها. جاءني رجل في يوم من الأيام وسألني عن مسألة شرعية، وقال لي: ألا يوجد ترتيب لهذه المسألة؟
قلت: لا، هذا هو التكليف الشرعي.
قال: حلها بطريقتك، إسأل الفقهاء مثلاً، حاول أن تجد نتيجة؟
قلت: المشكلة أنه يوجد نصوص في هذا الأمر ولا يمكن التغيير أبداً.
فقال: والله أنا أشعر بضيق من هذا الموقف.
قلت له: إذا كنت تريد الإسلام فعليك أن توسع صدرك ليدخل الإسلام إليه، أما إذا أردت الإسلام على قياسك وضيقت صدرك فستدخل إلى أمر آخر غير الإسلام، فاختر بين أن تكون مسلماً واسع الصدر أو أن تزيل الإسلام بضيق صدرك، وعندها لا تكون مع المسلمين.
أما العنوان الثاني لكربلاء فهو الشهادة، والشهادة خيار ولكن يخطئ من يظن أن الشهادة هي الخيار الأول، الشهادة هي آخر خيار في التطبيق العملي لكنها أول خيار في البناء العقائدي وفرقٌ كبيرٌ بين البناء والتطبيق، عندما تبني روحيتك على الشهادة يجب أن تكون مصداق البائع لله تعالى{إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} فالبيع من اللحظة الأولى عند العقد والاتفاق وعند عقد القلب على طاعة الله وعلى الإيمان بأصول الدين، لكن هذا لا يعني ان تكون الشهادة نتيجة طبيعية لكل حركة ولكل جهد، فهي الحركة المطلوبة في آخر المطاف عندما لا تنفع كل الجهود التي تبذل وتبقى الشهادة هي الجهد الأخير من أجل تحقيق أهداف الإسلام، وهذا ما حصل مع الإمام الحسين(ع)، وهذا يفسر لنا لماذا لم يقاتل الإمام الحسن(ع) وقاتل الإمام الحسين(ع)، لأن ظروف الإمام الحسن لم تكن تستدعي قتالاً وشهادة وستذهب الشهادة عبثاً ولن تؤدي ثمارها في الأمة، وهذا ما أدى بالإمام الحسين(ع) الذي استلم الإمامة في سنة خمسين للهجرة عندما استشهد الإمام الحسن(ع) وبقي تحت حكم معاوية عشر سنوات، عندما مات معاوية خلَّف ولده يزيد، أي أن الإمام الحسين(ع) عاش فترتين، فترة أولى مع معاوية مدتها حوالي عشر سنوات من خمسين للهجرة إلى سنة ستين للهجرة وهو الإمام المعصوم ليطبق مسار الحسن(ع) ثم بعد ذلك عندما تولى يزيد قام بموقفه وثورته واستشهد في مرحلة يزيد، لو لم يجد أن الشهادة هي الحل للمحافظة على الإسلام لم يكن ليستشهد، وهو أعطى لهم فرصاً كثيرة من أجل أن يعودوا عن غيهم، ومن أجل أن يعودوا إلى طاعة الله ربهم لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرص، فقرر المتابعة إلى آخر المطاف لأن الشهادة هي لحظة تثبيت الخط وليست الشهادة عطاءاً في كل المراحل كيفما كان، الشهادة نقطة الانعطاف نحو تثبيت المسار وليست أداءً يومياً عادياً يقوم به الإنسان في كل لحظة، لكن المهم أن يعرف الإنسان لحظة الانعطاف، والمهم أن لا يهرب الإنسان تحت لحظة الانعطاف تحت مبررات مختلفة، وهنا يأتي دور القيادة التي تنظر وتحكم وتشرع لنكون في الموقع الصحيح عندما نريد أن نقاتل، هذا ما فهمناه من أداء الإمام الحسين(ع)، وهذا الذي كان يجاهر به مستعداً من خلاله للشهادة، فعندما كان سائراً مع الحر يسايره قبل أن يصل إلى كربلاء، قال له الحر: أشهد أنك إذا قاتلت لتقتلن.فقال الحسين(ع) : أفبالموت تخوفني، فأنا أعرف فهذا أمر لا يمكن أن يخيفني وأن يرجعني إلى الوراء، وقال الإمام الحسين(ع) في حديثه مع أم سلمة زوجة الرسول(ص) عندما كان في المدينة المنورة وكانت تحادثه وتتحدث معه حول أسباب انطلاقه، قال لها: يا أماه، قد شاء الله عزَّ وجل أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وقد شاء حولي رهطي ونسائي مشردين، وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معينا" هذا الأمر كان واضحاً بالنسبة للإمام الحسين(ع)، لم تكن الأمور غامضة لكنه أقبل على الشهادة لأنها الحل في هذه اللحظة المنعطف، وكذلك كان الأصحاب فعبروا عن إيمانهم بقيادتهم، وعن إيمانهم بشهادتهم، وعن استعدادهم للعطاء، فقال زهير في ليلة عاشوراء: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرة . وقال مسلم بن عوسجة: والله لو علمت أني أقتل ثم أحرق ثم أذرى يفعل بي ذلك سبعين مرة ما عدوت، لأنه كان على استعداد أن يكون شهيداً ، فالأمر يتعلق بالإمام الحسين(ع) وأصحابه وأهل بيته، علي الأكبر قال للإمام (ع) في ليلة ذهابهم إلى كربلاء قال: أولسنا على الحق؟ قال له الإمام الحسين(ع): بلى، قال إمامنا علي الأكبر: إذاً لا نبالي أن نموت محقين. فطالما أن طريق الحق يستلزم القتال والقتل ونحن على الحق فلا بدَّ أن نموت شهداء قربة إلى الله تعالى.
هذه التربية على الشهادة أمرٌ مطلوب، وكما ذكرت الشهادة مطلب عقيدي عند الإيمان بالعقيدة وتطبيقها يستلزم ظروفاً تكون الشهادة فيه منعطفاً نحو تثبيت العقيدة، وإلا لا يمكن أن تكون الشهادة كيفما كان، لذا الشهادة تحتاج إلى إذن وإلى أن يكون الإنسان مبرأ الذمة قبل أن يقوم بها فلا يستطيع أي شخص أن يختار شهادته ويذهب إلى المعركة ويقاتل دون أن يأخذ أمر قيادته وأن يكون جزءاً من المجموعة التي يقاتل من خلالها.
إذاً هناك عنوانان لكربلاء: الموقف والشهادة، وهذان العنوانان عمل الإمام الحسين(ع) بطريقة أدائه مع أهل بيته وأصحابه ليثبتهما في الأمة تثبيتاً عملياً حتى تصبح الأمة مرتبطة بالخط فتقف إلى جانبه وتدافع عنه إلى آخر حد، فإذا استلزم الأمر شهادة استشهدوا في سبيل المحافظة على الخط، ولكن السؤال لماذا لم يفعل هذا الموقف ولم تفعل الشهادة فعلهما في فترة طويلة من الزمن؟
أصارحكم، بأن الإغراق على المستوى الفردي في تصعيد الحالة العاطفية في حب الإمام الحسين(ع) كبديل عن التكليف والدور هو الذي أقعد ومنع من أن تتحول حركة في الحياة، وفرقٌ كبير بين أن نأخذ الحسين قدوة فندخله إلى مجالسنا ونحاصره في عواطفنا ، وبين أن نجعله معبراً إلى قلوبنا يفجرها حتى نخرج إلى الشارع فنعمل قربة إلى الله تعالى على خط الإمام الحسين(ع)، لذلك نلاحظ أن هناك فئة من الناس أغرقوا كثيراً في التعبير الشكلي عن الارتباط بعاشوراء، وتفننوا كثيراً في محاولة إبراز العلاقة العاطفية، لكن حصروها في المجالس والمسارح والمواقع الضيقة، ولم تخرج من هذه الدائرة وأصبح التنافس في كيفية إحياء عاشوراء في الأيام بالأشكال والمضامين التي لا تخرجها من دائرة المجالس المنعقدة وعلى هذا الأساس حوصرت عاشوراء، بينما أرادها الإمام الحسين(ع) منطلقة لتفك الحصار حتى تتجاوز ضعف المسلمين من ناحية وسيطرة الحاكم من ناحية أخرى، إذن كيف نفك ضعفها ؟ وكيف نطلق عقالها؟
استطاع الإمام الخميني(قده) أن يأخذ عاشوراء من التاريخ وأن يدخلها في مفردات الحياة وأن يبقيها بدائرة التحريك، ومنع محاصرتها في دائرة المجالس ومنع محاصرتها في دائرة الطقوس الشكلية، وعزز إخراجها لتنطلق من مفردات السيرة إلى مفردات الحياة اليومية، وعزز الموقف السياسي والعملي في داخل عاشوراء، وإذا بعاشوراء تخرج في إيران لتنطلق قوة جماهيرية تتمكن من أن تسقط الشاه تحت عنوان عاشوراء ومنطلقاتها. وهو الذي قال:" كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء" ليقول بأن عاشوراء ليست في محرم، وعاشوراء ليست في أيام محددة من السنة، عاشوراء حياة وثقافة وتعبئة يجب أن تدخل في كل المفردات، وعاشوراء ليست في كربلاء فقط، عاشوراء في إيران ولبنان وفلسطين وفي كل مواقع العالم وفي كل مكان، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء أي أن عاشوراء يجب أن تتغلغل في حياتنا اليومية لتشملها بأسرها وحرامٌ بل جريمة عندما نحاصر عاشوراء في يوم أو مكان أو خصوصية لأنها بذلك تكون قد فقدت قيمتها وقدرتها في التأثير علينا، وستبقى لمن يستفيد منها ليعززها كعاشوراء في حياته، ولذلك قال الإمام الخميني(قده) في قول آخر:" كل ما عندنا من عاشوراء." النبي (ص) يقول "حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا" يعني الاستمرارية لا يمكن أن تكون بدون هذا الخط وهذه الرؤية وهذين العنوانين الموقف والشهادة، من هنا استطاع الإمام الخميني(قده) أن يخرج عاشوراء من دائرة المجالس الضيقة إلى دائرة الحياة فاستطاع أن يُسقط الشاه وأن يقيم دولة الإسلام المباركة في إيران والتي ننعم بخيراتها والتي نسأل الله تعالى أن تكون راية حق تسلم إلى الإمام المهدي (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء).
وفي لبنان أثرت عاشوراء ببناء ثلة من المجاهدين والمجاهدات، ولأكن واضحاً أكثر، كانت تحيا عاشوراء قبل عشرين سنة، وأحيينا عاشوراء بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، على الأقل أنا من الأشخاص التي سنحت لي الفرصة أن أطلع لقسم من الزمن قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعد ذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية، كنا نلاحظ عاشوراء قبل انتصار الثورة الإسلامية عاشوراء الإحباط والألم والمرارة والبكاء، ولكن بعد توجيهات الإمام الخميني(قده) أصبحنا نرى عاشوراء البكاء حباً وطاعة وحركة وحياة وأصبحنا نرى المجالس محركة من أجل التغيير، وأصبحنا نراها معبئة للشباب والأطفال من أجل أن يعيشوا جو الشهادة عملياً، بحيث ينطلق هؤلاء إذا دق النفير حتى واجهنا سيلأ من الطلبات لإخواننا وأخواتنا يرغبون الشهادة في سبيل الله، والله كنا نقف خجلين أحياناً أمام مراجعة الشباب في أنهم يريدون الذهاب ليكونوا إستشهاديين على درب الإمام الحسين(ع)، وهذه نتيجة عملية لعاشوراء، مما يعني أن بإمكاننا ان نجعل عاشوراء ذكرى وأن ننقل عاشوراء إلى الحياة، ليس المطلوب أن نعمق الثقافة لنفلسف عاشوراء لكن المطلوب أن نعمق الحب لعاشوراء حتى تكون حركتنا معبرة عما أراده الإمام الحسين(ع) من تثبيت الموقف ومن الدفاع عنه، وهذه هي المسؤولية التي تقع على عاتقنا.
أكثر من هذا أعتبر أن ما يحصل اليوم في فلسطين هو عملٌ عاشورائي، لأننا إذا فهمنا عاشوراء شكلاً ورسماً ومجلس عزاء فهذا يعني أننا حاصرنا عاشوراء، لكن إذا فهمنا عاشوراء حركة في الأمة تؤدي إلى الثقة بالنفس والعزة والثبات على الموقف والقتال والشهادة في سبيل الله فهذا يعني أن عاشوراء دخلت إلى فلسطين من غير مجالس عاشورائية تُعقد في البيوت.
ولن نقف أمام الجدل المقيت الذي يقول به البعض، هل يدخل هؤلاء الشهداء إلى الجنة، أولا يدخلون، لأن العنوان هو ولاية أهل البيت(ع)؟ ومن أعطاك صلاحية أن تمنح شهادات الولاية لأهل البيت(ع)، فكم من ولي لم يبرز شهادة وكم من شهادة كانت مزورة باسم الولي لأنها أبعدت الموالين عن الولي،دعوا عاشوراء تنطلق في العالم، ولا تأسروها في سجونكم، دعوا عاشوراء تحرك الأمة ولا تحتكروها كجماعة مخصصة، دعوا عاشوراء تصل إلى كل المستضعفين في العالم واتركوا رب العالمين يعرفكم يوم القيامة من كان مع عاشوراء ومن كان ضدها. وإلا سنصاب بعقلية جدلية حول عاشوراء، وستصبح عاشوراء محل أخذ ورد، إذا كانت عاشوراء لا تستطيع أن تخرج من مجالسنا فهذا يعني أحد أمرين: إما أن عاشوراء عاجزة، وإما نحن عاجزون إيصالها إلى غير مجالسنا، وبطبيعة الحال عاشوراء ليست عاجزة، إذن نحن العاجزون والضعفاء نحاول أن نخنق عاشوراء، ثقوا أن الشهداء الأطهار الذين يقاتلون في فلسطين قربة إلى الله هم مكرمون عند الله تعالى، والله يعلم ما في قلوبهم وما في نواياهم، ولم يعلمنا ويحملنا مسؤولية أن ندقق بالنوايا أو أن نكون أمناء على إدخال الناس إلى الجنة أو إلى النار.
من هنا نحن لا نرى عاشوراء محاصرة وخاصة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، وهذه النتائج هي تراكم كل الأعمال التي جرت خلال الفترة الطويلة السابقة بجهد أئمتنا(ع) وبجهد علمائنا الأبرار الذين أوصلوا عاشوراء إلى هذا المستوى الذي حركنا والذي قدم انجازات في الموقف والشهادة، وهذا الأمر يجب أن يتعزز عملياً ويجب أن نحافظ عليه، من بركات عاشوراء أن أطفالنا اليوم يحبون الشهادة دون أن يتقنوا فلسفتها ومعرفة أبعادها، فقد سبقونا بالعمل قبل أن نتمكن من التنظير لهم وهذا هو دور عاشوراء، لأن كثرة التنظير أقعد أهل الكوفة ومنعهم من القتال، فوالله لو لم يكونوا منظرين لقاتلوا في سبيل الله ولارتحنا من هذا المسار الذي أوجدوه بسبب كثر نقاشاتهم حول سلامة القتال وتأجيل القتال وإمكانية السلامة وإمكانية الفوز عند الله بصلاة لا تكلف دماء يمكن أن تعطى في دائرة الطاعة.
من هنا نحن مسؤولون في المحافظة على هذا النهج وعلى هذا الطريق لتبقى عاشوراء عملية، لذا من سأل عن فلسطين إذا كان بإمكان الفلسطينيين أن ينتصروا وأن يحققوا المستقبل، نقول له: ما دامت روح الشهادة موجودة في فلسطين، وما دام المجاهدون والمجاهدات يقدمون في سبيل الله فإن إمكانية النصر محققة بإذن الله تعالى ولو بعد حين، وفي المقابل مهما صنعت إسرائيل فإن إمكاناتها ستبقى محدودة، بإمكان إسرائيل أن تقتل لكن ليس بإمكانها أن تقتلع حب الشهادة والجهاد، بإمكان إسرائيل أن تسيطر على الأرض لكن ليس بإمكانها أن تسيطر على النفوس والعقول، بإمكان إسرائيل أن تحقق خطوات في المجازر والعدوان لكن ليس بإمكانها أن تثبت حقاً ليس لها أو أن تثبت معلماً ليست مهيأة له، من هنا علينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نتابع، وماذا ستصنع الدول الكبرى؟ ها هي الدول الكبرى عاجزة، يستطيعون اختراع القنابل الذرية والنووية والطائرات والدبابات من أجل مواجهة القوة العسكرية وهذا نعترف لهم به، لكن لن يستطيعوا اكتشاف دواء يمكن أن يواجه الشهادة في سبيل الله تعالى، فهذا سرٌ موجودٌ عندنا كلما عززناه كلما كنا أقوى، وأسلحتهم مخصصة للقتل، فإذا كنا مستعدين للشهادة فهذا يعني أن تسقط أسلحتهم وأن نكون الأقوى شرط أن نتابع ونستمر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا على النهج الحسيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته