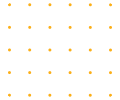مبادلة الأذية بالإحسان
مبادلة الأذية بالإحسان
تبرز في هذه الفقرة من الدعاء إيجابية المؤمن في مقابل سلبية الآخرين، ومبادرته نحو الخير في مواجهة الشرور، ومبادلته للأذية بالإحسان، فنظرهُ منصرف إلى مكارم الأخلاق، وأمله برضى الله لا برضى هواه، لذا نراه يترفَّع عن السلبية في الرد على الغش والهجر والحرمان والقطيعة والغيبة، فيتصرف بعكس هذه الأفعال بما يوازيها من الفضائل، فيرد بالنصيحة والبر والبذل والصلة وحسن الذكر.
لاحظ أيها العزيز، تلك المبادرات في أسمى معانيها، تواجه الأعمال السيئة في أخسِّ نتائجها، في صورة يرسم من خلال المؤمن التقي خطوات رقي النفس في عالم المكلوت، محققاً بأدائه مكانة راقية يشع نورها في استقامة مؤثرة وفاعلة لإعمار الأرض في طاعة الله تعالى. وهي صورة تُكسب صاحبها طمأنينة وأمناً واستقراراً في أجواء القلق والخوف والإرباك، وكأنَّه يعيش في عالم آخر تملؤه العفة والأخلاق، لكنَّه في عالم الدنيا لم يتلوث بأرجاسها، ولم ينفعل برذائلها، بل أحاطت به مكارمه فحمته مما سقط فيه الأغيار، ورفعته فيما ارتفع به الأبرار.
ستة مواقف متكاملة، ترسم لنا حلقة الاتصال في السلوك إلى الله، بما يضيء حياتنا:
1- النصيحة مقابل الغش: بعض الناس يغشون، فيضعون الماء في الحليب عارضين بيعه على أنَّه صافٍ ونقي، أو يضعون قطعة على الثوب تشير إلى بلد الصنع المختلف عن بلده الحقيقي، أو يغيرون تاريخ الصنع بانتهاء الصلاحية بوضع تاريخ جديد مزوَّر، أو يقدمون معطيات عن قطعة أرض مخالفة لحقيقتها، أو يعرضون شقة للبيع ويدلسون في مواصفاتها فيخفون معايبها، أو يشجعون على عمل بترويج خاطئ خلاف حقيقته، هذه تصرفات محرَّمة. روي أن رسول الله(ص) مرَّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال رسول الله(ص):"أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشَّنا ليس منَّا"(172).
فلو ابتليت ببعض هؤلاء فغشوك فيما كنت ترجو منهم النصيحة، وآذوك أو خسَّروك بسبب تصرفاتهم، ماذا تفعل لو أتاك أحد منهم يستنصحك، وأنت قادر على رد الصاع صاعين، وتوريطه في أزمة أو خسارة كبيرة؟ هل تنتقم لنفسك فتغشه أم تترَّفع عن ذلك وتنصحه؟ يوجهنا الإمام زين العابدين(ع) أن نعارض الغش بالنصيحة، وأن نطلب من الله التسديد والعون كي لا يجرفنا هوانا إلى الانتقام. ومما ورد عن الإمام زين العابدين(ع) في رسالة الحقوق في حق المستنصح:"أن تؤدي إليه النصحية، وليكن مذهبك الرحمة والرفق به"(173)، بصرف النظر عن تصرفاته معك وغشه لك، فعملك رصيد لك في هذه الدنيا، وأنت تعبِّر من خلاله عن أخلاقك، وجزاؤك الثواب الجزيل عند مليك مقتدر.
2- البر مقابل الهجر:"وأجزي من هجر بالبر، أي أعطيه الصلة مقابل هجرانه لي، بأن أبادر للاتصال به، وأُبقي العلاقة معه، على الرغم من أنَّه قطعني ولم يتصل بي، فردّي عليه بالبر مقابل الهجر. لا تبحث عن رد الفعل على تصرفه، ولا تجاريه في انقطاعه عنك، ولا تحسب حساباً للاعتبارات الشخصية والاجتماعية التي تأسرك بقيودها. اقتحم هجره بالبر، وبادله بالتي هي أحسن، ولا تنتظر منه مكافأتك، فأنت تقوم بالأداء السليم، وأنت رابح بوصل ما انقطع، ولعلَّ سلوكك هذا معه يوقظ ضميره ويعيده إلى الصلة.
3- البذل مقابل الحرمان: كم هو عزيز عليك أن يحرمك أخوك حقك من غير مسوغ لذلك! كم هو مؤلم لك أن لا يُنصفك من موقع مسؤوليته مخالفاً بذلك الأنظمة أو مستغلاً لموقعه! كم هو مؤذٍ لك أن تخسر مالاً أو أرضاً أو إرثاً أو مكسباً بسبب اعتداء صديقك أو قريبك الذي حرمك من ذلك، بشهادته الخاطئة، أو إخفائه لبعض المعطيات، أو رغبته بالكسب بدلاً عنك!
ما الذي عليك فعله عندما تكون مقتدراً على حرمانه، سواء أكان صاحب حق أو كان بحاجة إلى البذل والعون؟ ما أروع التوجيه السجَّادي لإمامنا العظيم، إنَّه يأمرك أن تثيب من حرمك بالبذل، مع أنَّ الثواب يكون مكافأة على عمل، والحرمان يستوجب عقاباً لمرتكبه، لكنَّ إيمانك يدفعك لأن تبذل حيث تستطيع، ولو كان البذل لمن حرمك، فتعيش روحية الثواب في الإعطاء بطيب خاطر، ليكون بَذْلُكَ مؤشراً على كرم نفسك في تعاليها عمَّا ارتكبه المخالف من صغائر وآثام، وهذا ما يحقق الطمأنينة والراحة في داخلك.
4- الصلة مقابل القطع: يغلب على الخلافات بين الأصدقاء والجيران والأخوة الطابع الشخصي والتافه، فترى القطيعة بسبب كلمة أو زيارة أو حادثة أو غير ذلك...ولا أريد التهوين من بعض المشاكل التي تحصل، لكن هل يصح أن تصل الأمور إلى حد القطيعة؟ وهل يبقى للإنسان أصدقاء أو علاقات لو أراد التوقف عند كل حادثة؟.
قد يقول البعض بأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العلاقات مع الآخرين! وفي الواقع، لا نقيس الصلة بالحاجة أو عدمها، وإنما بالروحية التي ننظر من خلالها إلى الاجتماع الإنساني، والتي يريدها الإسلام سموحة ومنفتحة وخالية من الغِل والحقد والمنازعات، أي بمعنى آخر، يحثنا الإسلام على السِّلم بيننا بدءاً من التحية"السلام عليكم"، ومروراً بكل التنازلات الفردية التي تُبقي العلاقات قائمة بين الأسرة الواحدة، والمجتمع الواحد، والأصدقاء، والأخوة.
من هذه الزاوية يمكننا فهم الإطار التوجيهي العام للتنازل والإعطاء من دون ابتغاء البدل، واحتساب الأجر على الله تعالى، والسمو في نموذج الشخصية المسلمة. قال رسول الله(ص):"ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟:العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك"(ب).
5- حسن الذكر مقابل الغيبة: الغيبة مرض اجتماعي فتَّاك، فهو يسري بين الناس كالنار في الهشيم، ويخرِّب العلاقات الاجتماعية بينهم، ويمس الحقوق المباشرة للأفراد بسبب كشف عيوبهم المستورة عن الآخرين، وهذا ما يجعل الموقف صعباً للمستغيب. فعن رسول الله(ص):"إياكم والغيبة، فإنَّ الغيبة أشد من الزنى، إن الرجل قد يزني فيتوب، فيتوب الله عليه، وإنَّ صاحب الغيبة لا يُغفر له حتى يغفر له صاحبه"(ج).
وفي خبر معاذ الطويل المشهور عن النبي(ص):"الحفظةُ تصعد بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس، حتى إذا بلغ السماء الدنيا، والحفظة تستكثر عمله وتزكيه، فإذا انتهى إلى الباب، قال الملك بالباب:اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرني ربي أن لا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي". وعن أنس قال(ص):"مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم باظافيرهم، فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال:هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم"(د).
لكن لو سنحت الفرصة للمُستغاب أن يذكر عيوب من استغابه في مجلسٍ ما، هل يرتكب هذا الجرم انتقاماً لنفسه؟ يربينا الإسلام على عدم المبادلة بالإساءة، وعلى عدم ارتكاب الحرام مقابل الحرام، فجرم الآخر لا يبرر جُرمنا، ولكلٍّ حسابه، ولا فائدة من رد الفعل، فالأولى المبادلة بحسن الذكر، بحيث لو جرى الحديث عن المستغيب في محضر المُستغاب، لأجاب الأخير بالصفات الإيجابية لمن استغابه، وهذا هو الخلق الإسلامي الصحيح، ففيه أجر ذكر حسنات صاحبه، وأجر تلقي الأذية منه من دون ردِّه عليها.
6- شكر الحسنة والغض عن السيئة: المؤمن في موقع العطاء دائماً، والإحسان من الصفات التي يجب أن يتحلى بها، قال تعالى:" وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"(هـ). وهو لا يقابل الإساءة بالاساءة بل يرتقي في سُلَّم العفو والتسامح ليحاكي الصفات الكمالية في تراكمها بعطاءاته في كل المجالات. فهو من الذين قال عنهم جلَّ وعلا:" وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"(و)، ومن الذين يدرأون بالحسنة السيئة، قال تعالى:" وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"(ز).
أيها العزيز، عندما تشكر الحسنة فقد فعلت خيراً، وشجَّعت الآخرين عليه، وكنت لائقاً بما أصابك منه. وعندما تغض عن السيئة فتعفو عنها، ولا تقابلها بمثلها، عندها تتجلى في روحك حالة من الراحة النفسية الناتجة عن ترفعك عن هذه الأمور البسيطة الزائلة، وعن انصراف اهتماماتك بما يرفعك عند الله في يوم القيامة. وفقنا الله وإياك إلى خيرات هذه المكارم.