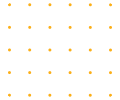العلم الديني والعلم العصري
العلم الديني والعلم العصري
ورد في الحديث الشريف:"العلم علمان:علم الأديان وعلم الأبدان"(120).
أمَّا علم الأديان أو العلم الديني، فهو الذي يُعرِّف الإنسان على حقيقة حياته وما يحيط بها، ويجيب عن أسئلة بداية الخلق والمعاد وصفات الخالق ودور المخلوق، ويتكفَّل بتحديد المنهج الأفضل لكمال الحياة على مستوى الوعي وتربية النفس والسلوك، ويحدِّد علاقات الإنسان الثلاثة بشكل نموذجي، مع ربه، ومع نفسه، ومع مجتمعه بما يشمل فئاته المختلفة.
أمَّا علم الأبدان أو العلم المادي المعاصر، فهو الذي يبحث في المحسوسات التي ترتبط بجسد الإنسان، وما يحيط به في الأرض والسماء وما بينهما، فيما خلق الله تعالى من حيوان ونبات وجماد، ليتعرَّف الإنسان على أسرارها وخصائصها وقوانينها، فيستفيد منها في حياته وحاجاته اليومية ورغباته المستقبلية.
فالعلم الديني يُبيِّن منهج الحياة وطريق الهداية،"إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً"(121)، والعلم المادي يكشف أسرار الطبيعة، التي تُعين الإنسان على التحكم بمقدراتها لمصلحته، "اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(122).
ولا يمكن الاستغناء بالعلم المادي- أو العصري كما يسمونه- عن العلم الديني، فالعلم المادي يفتح آفاق التعاطي مع الحياة المادية، في مسائل الفيزياء والكيمياء وإدارة الأعمال والمحاسبة والكمبيوتر والتجارة وأنظمة السير واستخراج الثروات الطبيعية...،ويعرِّفنا على متطلبات الإنسان وحاجاته الجسدية والصحية والنفسية، وقدراته العقلية وخصائص النمو لديه، كلُّ ذلك بطريقة تجريبية غالبة في التوصل إلى النتائج العلمية الدقيقة. لكنَّه لا يعطينا المنهج الأكمل لإدارة حياة الإنسان في علاقاته الثلاث مع ربه ونفسه ومجتمعه، بل يُخضعها للتجارب والاحتمالات التي تتغير وتتبدل دائماً، بعنوان التطور والحداثة، ما أوقع ويوقع البشرية في حقل تجارب متكررة وغير نهائية وقاسية في نتائجها، كما هي النظريات المتنقلة بين الاستبداد والديمقراطية، والنمط الأخلاقي الأفضل وتنظيم الأسرة ومدى حرية الجسد، وسيطرة العامل الجنسي أو كبته أو تنظيمه، ودور الروح مع الجسد... وما أنتجته هذه النظريات من ارباكات في التربية، وخواء روحي في المجتمعات الغربية، وضياع في تلمُّس بوصلة الهداية المستقرة. لذا تكون الحاجة ملحَّة للعلم الديني الصادر عن الخالق العالم بشؤون خلقه وما يصلحهم، والذي يتعرض لثوابت الهداية التي توازن بين الروح والجسد، الدنيا والآخرة، العقل والعاطفة، كما هو الإسلام الشامل الكامل:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً"(123).
إننا ندعو إلى الجمع بين العلم الديني والعلم العصري، فيتعلم المرء من دينه ما يساعده على الهداية، وعلى توضيح تكاليفه ومسؤوليته، ثم يزيد بمقدار رغبته في التوسع والرقي، أو ربما للاختصاص في بعض الحالات. ويتعلم من العلوم العصرية، ما يساعده على معيشته وترتيب شؤونه، ثم يزيد بمقدار طموحاته وقدراته، لينتفع وينفع مجتمعه، على ان يحافظ على الحد الأدنى الضروري من العلم الديني.
بعض الأشخاص يغرقون في دراساتهم واهتماماتهم العلمية، ويحصرون أنفسهم بها، ومع أن الغالبية منهم تعيش حالة إيمان وذهول أمام عظمة الخالق، فيما يكتشفونه من أسرار ودقة وتنظيم، إلاَّ أن الأقلية تنحرف في معتقداتها لأحد سببين:
الأول: إنهم ينظرون إلى المادة التي يكتشفون خصائصها بمعزل عن خالقها، بل يجرِّدونها عن الخالق، ويتعاملون معها كوجود قائم بذاته، ثم يعيشون الزهو فيما يتعرَّفون عليه، فيصابون بمرض العظمة، وينسون عجزهم وعطاءات الله تعالى من نِعَمِهِ لهم، فيكفرون، ويسخِّرون نتائج دراساتهم للابتعاد عن الدين، وما استنتجوه لا يغيِّر من حقيقة ارتباط الكون والحياة والإنسان بالخالق العلي القدير. فالنتيجة الخاطئة التي وصلوا إليها ثمرة المقدمات والمنطلقات الخاطئة.
الثاني: انهم يعزلون أنفسهم عن كل شيء في الحياة، وينمُّون آفاقهم العلمية المادية على حساب متطلبات الجسد والروح والفطرة الإنسانية، فيعيشون انعدام التوازن، ويصابون بعقدٍ نفسية واستنتاجات خاطئة، لأنَّ علمهم في الجانب المادي لا يجعلهم قادرين على فهم الجانب الإنساني من جوانبه المختلفة، ولا يُمكِّنهم من فهم الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، فيكون نظرهم قاصراً في هذه الأمور، وتكون أحكامهم خاطئة لأنها غير مبنية على مقدمات كافية وصحيحة.
أمَّا العلم الديني، فيسمو بمن تابعه إلى أعلى مراتب الهدى والتقوى والطمأنينة والاستقرار، ويحقق له تفاعلاً دائماً ورُقياً مستمراً، وقد ارتقى أئمتنا(عم) بما امتلكوا من العلم الرباني، وانفتح لأمير المؤمنين علي (ع) ألف باب من كل باب، قال(ع):"علمني رسول الله(ص) ألف باب، يفتح كل باب إلى ألف باب"(124).
ووصل علماء كبار إلى درجات عالية، كالشيخ المفيد، وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، والعلامة الحلي، والشهيدين الأول والثاني، والإمام الخميني(قده) وغيرهم، وتركوا آثاراً
عظيمة من علمهم وسلوكهم، جعلتهم في المصاف الأرفع في خشية الله تعالى:" إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"(125).
فإذا وجدنا انحرافاً عند البعض ممن سلكوا طريق العلم الديني، فلأنهم أخطأوا المسار، وذلك بأسباب ثلاثة:
أولها: وأبرزها حب الدنيا والإقبال عليها، فالدنيا رأس كل خطيئة، وملذاتها متاع زائل يسقط فيه من أغرته زينتها،"زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ"(126)، وأخطر ما فيها اتباع السلطان، ليكون من وعاظ السلاطين، والمروجين لانحرافاته السياسية والمالية، والمنظرين له بتحريف معاني الآيات والروايات بما يخدم عرشه، وفي هذا يقول الرسول(ص):
"الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.
قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟
قال: اتباع السلطان، فإن فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم"(127).
ثانيها: أن يعتمد على نفسه في الفهم الديني، من دون العودة إلى معلم يرشده إلى الأصول والقواعد، فتتشوش أفكاره من الفكر الالتقاطي ، ويقع أسير الدسائس والتأويلات الخاطئة والمنحرفة، ويسلك في التفسير والفهم الديني مسالك خاطئة تؤدي به إلى استنتاجات خاطئة وضالة. وقد رأينا بعض من اعتمد على فهمه اللغوي، وساق التفسير للقواعد والآيات القرآنية على أساسه، من دون الاتكاء على الأصول التي اعتمدها العلماء، فتوصَّل إلى نتائج مغايرة تماماً لما أجمع وتسالم عليه علماء الإسلام.ورأينا من جمع أحداثاً معينة، أضفى عليها تفسيره وفهمه، من دون ملاحظة الظروف والأسباب وارتباط هذه الأحداث بما قبلها وما يحيط بها، فتوصَّل إلى استنتاجات بعيدة عن حقيقة الإسلام.
ثالثها: نزع الشمولية عن الإسلام، والاعتماد على جانب واحد فيه، وتركيز الفهم والسلوك والموقف على أساس هذا الجانب، بشكل معزول عن الجوانب الأخرى. فالتعاطي مع الإسلام كعبادات فقط يعزله عن الحياة الجهادية والسياسية، والتعاطي معه كسياسة فقط يعزله عن الجانب التربوي والروحي، والتعاطي معه كالتزام تقليدي يُبعده عن التأثير في تطوير المجتمع، وكذلك الجمود على تفسير معين من دون الاجتهاد والإجابة على الأسئلة المعاصرة، يحاصره عن تلبية مستلزمات وحاجات الإنسان.
ولا يُؤتي العلم الديني أو العلم المادي ثماره ما لم يصاحبه تزكية للنفس، لأنَّ الدافع الداخلي يحكم مسار الحياة نحو الهدى أو الضلال، فلا تكفي ظواهر الأمور، فقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، لكنَّ قيمته الفعلية بالإيمان والعمل الصالح:" لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ"(128)، وما لم يزكِ نفسه ، لن يصلح قلبه ونفسه، بما ينعكس على حياته.قال تعالى:" لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ"(129).
فالعلم والتزكية متلازمان، ولا نفع للعلم من دون التزكية، كما يقول الإمام الخميني(قده):"إنَّ العلم يصبح مفيداً حينما توجد التزكية والتربية الروحية والأخلاقية، في الجامعات وسائر المراكز التعليمية، سواء تلك التي تخرِّج علماء الدين أو علماء العلوم الأخرى. يجب أن يكون في هذه المراكز جميعها أفراد يعملون على تربية الطلاب أخلاقياً وتزكيتهم روحياً"(130).
يجب أن تواكب تزكية النفس كل مراحل حياتنا، لأننا بحاجة دائماً إلى مَدَدٍ روحي يعيننا على تقلبات الحياة، ويُحدث التوازن في داخلنا، ويقوي بصيرتنا، وبذلك نقوى على حسن الأداء لما فيه سعادة الدارين. قال رسول الله(ص):"العلم علمان:علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع"(131).