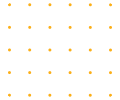توازن النفس
توازن النفس
هذه هي المحطة الهامة لتحديد مسار الإنسان، إنَّها النفس التي تثبِّت توجيهات السلوك، وتؤثر على الأداء، وتتحكم بالانطباعات وتقييم الأحداث، وتحدِّد النظرة إلى القضايا المختلفة. إنَّها النفس التي إذا اطمأنت واستقرت لامست الحياة بطريقة مختلفة عمَّا لو كانت مريضة ومتأزمة، وبالتالي فإنَّ الناس لا ينظرون إلى الأحداث بطريقة واحدة، ولا يتعاملون مع الظواهر بطريقة واحدة، إنما ينطلقون من داخل أنفسهم فيعطون الانطباعات المختلفة بحسب اختلاف أنفسهم.
احذر أمراض النفس الإنسانية ومنها الشعور بالرفعة والزهو والكبرياء، فهي تعيق رقيك في دروب العلى ومكارم الأخلاق، وضع الأمور في مواضعها، فالمكاسب الدنيوية مؤقتة، والآلام مؤقتة، وكلاهما اختبار لآخرتك.
يقول الإمام زين العابدين(ع):"ولا ترفعني في الناس درجة إلاَّ وحططتني عند نفسي مثلها"،فإذا وفقتني يا رب لكسب مال وغنى، أو تحصيل علم متقدم، أو استلام موقع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو علمي مهم، أو تميّز في نتائجي المدرسية عن زملائي، أو براعة في الخطابة والمحاورة والاقناع للجلساء، أو جمال ظاهر للعيان بين أقراني، أو قوة تجعلني مهاب الجانب من الأعداء، أو تقييم إيجابي ومتقدم من الناس لي بحيث يبرز ذلك في كلماتهم وإشاداتهم بي، أو أخلاق تجعلني منظوراً للآخرين بحيث أسمع منهم الإطراء والتزكية... يا رب إذا جعلتني راقياً في نظر الآخرين، ثم عشت حالة من الزهو في ذلك في داخل نفسي، فاجعلني قادراً على مواجهة هذا الزهو والرفعة، بأن أحدِّث نفسي عن ضعفها وعجزها وفقرها، وانها ما كانت لتحصل على هذه المكانة لولا توفيقك، وأنَّ عليَّ أن أتواضع في مثل هذه الحالة.
عن رسول الله(ص):"كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه بالأصابع. قالوا:يا رسول الله وإن كان خيراً؟ قال: وإن كان خيراً، فهو شرٌ له إلاَّ من رحمهُ الله، وإن كان شراً فهو شر"(108). لماذا؟ لأنَّ الاشارة إليه بالأصابع تضعه في موضع الإشادة أو التهمة، وكلاهما يعرِّضه للإثم، أمَّا الإشادة فنتيجة الإيجابيات التي تبرز وهي خير، لكنَّ تفاعل النفس معها وشعور الإنسان بالرفعة يؤدي إلى السلبية والإثم، فإذا لم تؤد إلى الرفعة فهذا خير، وهي رحمة من الله تعالى، وأمَّا التهمة فإذا كانت لسلبية ظاهرة فهي شر وإثم بطبيعة الحال.
إنَّ الاشارة بالأصابع شاملة لأمور الدين والدنيا، فقد يشيرون لموقع عالم دين أو طالب علم أو المتدين لوعيه واستقامته وحسن كلامه وأخلاقه ومستوى عبادته وعلائم التقوى على وجهه وفي أعماله، وقد يشيرون لكسب دنيوي في المال أو الجاه أو الرئاسة أو النجاح مما يشمل عامة الناس، فالفتنة بذلك لا تختص بفرد دون آخر، ولا بجماعة دون أخرى، إذ لكلٍ مسألةٌ أو مسائل تجعله معرضاً لهذا الاختبار الذي يجب الانتباه منه. إنَّ من صفات المؤمن كما ذكر أمير المؤمنين علي(ع)أنَّه:"يكره الرفعة ولا يحب السمعة"(109)، في المقابل هناك من يحِّب أن يُشار إليه، وأن تُذكر صفاته الإيجابية في كل محفل ومنتدى ولقاء، بل أن تُضخَّم وتكون أكبر من واقعها، وهذا ما لا ينعكس على النفس من داخلها فقط، وإنما ينعكس على العلاقة مع الناس وكيفية التصرف معهم.
مسكين هذا الفقير الذي أغناه الله تعالى بفضله فتغيرت نظرته إلى الأمور، واصبح يتعاطى مع الناس وخاصة الفقراء منهم بفوقية!ألم يكن واحداً منهم؟ ألم يعش همومهم وطريقة تفكيرهم؟ ألم يكن يتألم من المتكبرين؟!
مسكين ذاك التلميذ الذي تدرَّج في العلم إلى أن حصل على الشهادات العليا، وأصبح يشعر بتميزه وينظر نظرة دونية للتلامذة أو للآخرين مِنْ دونه! ألم يمر بهذه المرحلة؟ ألم يتأذى من أستاذ شمخ بأنفه أمامه وأمام زملائه؟ وهل نسي فضل الله عليه في منحه العقل والقدرة والظروف التي ساعدته للوصول إلى هذا المستوى؟
تعساً لذلك المتبختر إذا كان حاكماً أو مديراً أو مالكاً أو أياً كانت رتبته ومكانته، ما الذي جعله لا يضع النعمة موضعها ولا يشكر خالقه عليها؟ ألم يكن طامحاً وراغباً لها، راجياً ربَّه أن يوفقه للحصول عليها؟ وقد حصل عليها!، فليلتفت إلى أنها عطية من رب العطايا، وليتواضع فيما حصل عليه، فهذا أدوم للنعمة والتوفيق.
ذكر لنا رسول الله(ص) المعادلة التالية:"من تواضع لله رفعه، ومن تكبَّر خفضه الله"(110) ، وهي معادلة للحياة، فرفعُ الله للإنسان بالتواضع، رفعٌ في الدنيا بين الناس، بحيث يزداد مكانة ورفعة وسمعة من دون أن يسعى إليها، فهي نتيجة طبيعية لأدائه وتواضعه وتوفيقه. وأمَّا خفض الله للإنسان بتكبره، اسقاطٌ لمكانته وسمعته بين الناس، كنتيجة متلازمة مع سوء أخلاقه، وعدم تقبل الآخرين لهذا النمط.
نحن بحاجة دائماً إلى تربية النفس على الأجواء الطاهرة النقية الخلوقة، فلكل أثر خارجي في حياة الناس، انطلاقةٌ داخليةٌ من النفس الإنسانية، فالمتواضع بين الناس متواضع مع نفسه، بينه وبين الله تعالى، والمتكبر على الناس يعيش الكبرياء والرفعة في داخل نفسه، من وسوسات الشيطان وإغراءات النفس الأمارة بالسوء.
بما أن الواقع النفسي هو الأساس، فقد توجه إليه الإمام زين العابدين(ع) بالتربية، بالطلب من الله تعالى،"إلاَّ حططتني عند نفسي مثلها"، وهنا لا يقصد تحطيم المعنويات، ولا يقصد إلغاء مشاعر الاستئناس بالإنجازات والمكتسبات، لكنَّه يريد تهذيب النفس كي لا تخرج عن حدِّها المستقيم. فيا رب، عندما يراني الناس مهماً، ويتحدثون عني، ويذكرون ذلك أمام مسامعي، لا تجعلني أعير اهتماماً لما يقولونه بأن أرتب أثراً في طريقة تصرفاتي، بل اجعلني أعيش فكرة الرفض لما يصفوني به، فأنا لست مهماً كما يعتقدون، ولست راقياً كما يقولون، ولست مميزاً كما يدَّعون، إذ ما يهمني هو أن أكون كذلك في صحيفة أعمالي التي ترتفع إليك، وما قيمة أن يكون تقييمهم كذلك بينما لا تقيمني في هذه الرتبة، ولو افترضنا أني كنت كذلك، فاجعلني لا أتأثر ولا أرى نفسي في تميُّز مكانتها، ولا أرى عملي أكبر من حقيقته.
ولو كانوا يرون عملي عظيماً، فاجعلني يا رب أسيطر على مشاعري فلا تفلت من عقالها ولا تتجاوز حدود تواضعها، واجعلني يا رب قادراً على رفض ما يعتقدونه فيَّ، لا لأني لست كذلك، بل لأني لا أريد أن أحصل على حب السمعة والرفعة، فإذا رفعتني في الناس درجة، مكنِّي لاخفض مكانتي عند نفسي درجة، لأُحدث التوازن في داخلي، وأرى الطريق بوضوح للوصول إلى الهدف. وإذا حصل أُنسٌ لي بما يتحدثون به عني، فلا تحوله يا رب علواً في داخل نفسي، فأنا بحاجة إلى أن أرى نفسي في الطريق للوصول إلى الهدف الأسمى، لا أن أتوهم الوصول وتجاوز المراحل، وإلاَّ ضعفت همتي، وتعاظمت نظرتي لأعمالي، ولا حلَّ واقعياً ومؤثراً إلاَّ إذا بنيتُ على مرضاتك التي تستلزم تواضعي، ولم ابنِ على إشادة الناس بي بما يُحدث لي رفعة وزهواً وكبرياء، فتخفيض الدرجة في النفس مقابل ترفيع الناس لي درجة، خطوة ضرورية لإبقائي في خط التوازن والاعتدال والاستقامة.
أعنِّي يا رب بدعائي لك، فالدعاء يهذب النفس ويرقى بها إلى السمو والارتباط بخالقها القدير، وأنا بحاجة أن أناجيك لتعينني، أنت الذي تساعدني على نفسي، فلا تكلني إلى حولي وقوتي، وإنما أعنِّي بحولك وقوتك. أنت الذي رفعتني في الناس، فأعني على تخفيض ذلك في نفسي، مع علمي بأني المسؤول لقولك في كتابك العزيز:" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا *وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"(111)، لكنَّ عونك يسهِّل اختياري.
لاحظ نفسك أيها العزيز، فإنَّها مفتاح الخيرات والشرور، إنْ أصلحتها نجوت، وإن استسلمت لاغوائها هلكت، فاعمل عليها بكل جهدك لتتمكن من الإمساك بها وقيادتها، فعن أمير المؤمنين علي(ع):"أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه"(112)، ويبدأ إصلاحها بمواجهة المؤثرات عليها ومنها السمعه بين الناس.
وكذلك إذا شعرتَ بالعزة والرفعة ولم يشر الناس إليك بذلك، إعمل على نفسك أيضاً لتدفعها نحو التوازن، قال الإمام زين العابدين(ع):"ولا تحدث لي عزَّاً ظاهراً إلاَّ أحدثتَ لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها"، وهذه حالة أخرى، في أن تكون موفقاً أو ناجحاً أو منتصراً أو متفوهاً أو متصدراً، ما يسبِّب عزاً ظاهراً للعيان، يدفعك للاستئناس بالميزة التي حصلت عليها، والتي قد تتحوَّل إلى زهوٍ ورفعة وكبرياء، فأنت بحاجة إلى تعبئة نفسك في الاتجاه المعاكس، على القاعدة نفسها التي تحدثنا عنها في الارتفاع بنظر الناس، بإحداث ذلةٍ باطنة في داخل نفسك، بالمقدار نفسه للعزة الظاهرة، ليهدأ داخلك في التعامل مع المكتسبات التي حققتها، ويصلح ظاهرك في انعكاس تصرفاتك أمام الآخرين، عندها لا يخالط العزَّ الظاهري أي إثم.
إذا نجحت في عملك أو مدرستك أو مسؤوليتك، وكان النجاح ظاهراً وواضحاً بين الناس، فأنت أمام احتمالين:
الأول: أن تتعامل مع النجاح بشكل طبيعي، وتشكر الله على ما أنعمه عليك، وتترك لنجاحك أن يفرض نفسه من دون ترويج أو مباهاة، وتكون مستأنساً ومرتاحاً من دون مبالغة، وتحدِّث نفسك بضعفك وبأنك لم تحقق كامل الأهداف، ولا ترى لنفسك منَّة أو مقاماً مميزاً، ثم توجهها لتتواضع كي لا تتمادى مع العزة.
الثاني: أن تتعامل مع النجاح بفرح مفرط، وزهو بارز، وأن تنسب الفعل إليك، وتنسى المنعم عليك، وتروج لنجاحك، وتكرر الحديث عنه أينما جلست، وتخاطب نفسك بدعوتها لتشمخ إلى الأعلى، فهذا إنجازها! ثم تعيش الكبر في داخلك ما ينعكس على أدائك بين الناس.
يدعونا الإمام زين العابدين(ع) إلى الاحتمال الأول في تخفيض مستوى العز الظاهري بالذِّلة الباطنية، في مقابل سيئات الاحتمال الثاني في الكبر الباطني الذي يصاحب العز الظاهري ويتفاعل معه ليصبح مرضاً في النفس والسلوك. لأننا بالذِّلة الباطنية نربح الكثير، إذ نتعامل مع الدنيا بحدودها، فكل إنجازاتها مؤقتة، وما حصلنا عليه هو جزء يسير منها، والعبرة بما نجمعه في نهاية المطاف ليوم الحساب:"تِلْكَ الدَّارُ الآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ"(113)حيث جعل الله الدنيا مسرح العمل، فكيفية التعامل معها طريق النجاة أو العذاب، ويرتبط اختبار النفس بما يحدث في هذه الدنيا. قال أمير المؤمنين(ع):"آفة النفس الوله بالدنيا"(114)، لأن التعلق بالدنيا هو الذي يدفع الإنسان للبحث عن أسباب علوه فيها، وهو الذي يحولها إلى هدف دائم خلاف حقيقتها ودورها، وهنا تلعب النفس المنجذبة إليها الدور الأساس في الانحراف، ما يجعل وظيفتنا أن نوجهها نحو صلاحها بالعمل عليها في عدم الاستجابة لمظاهر الدنيا من العز وعلو الدرجات، وذلك بالتعامل مع هذه المظاهر بشكل طبيعي وعادي في أنها إنجازات العمل الإنساني بما أعطانا الله إياه، لنشكل ذخيرتنا للآخرة، لا لنستبد بها بين الناس.